
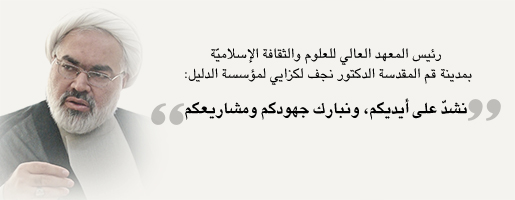
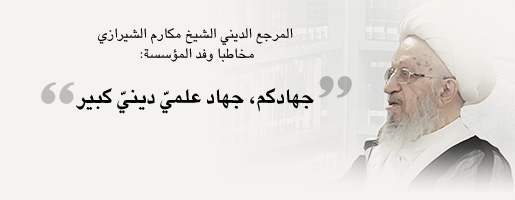


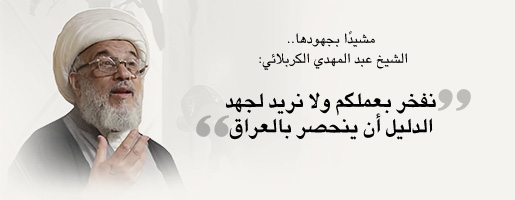
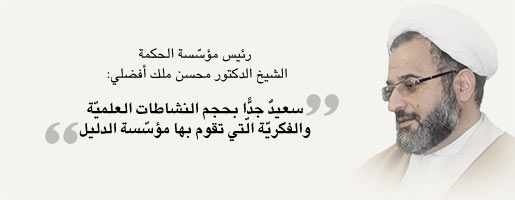


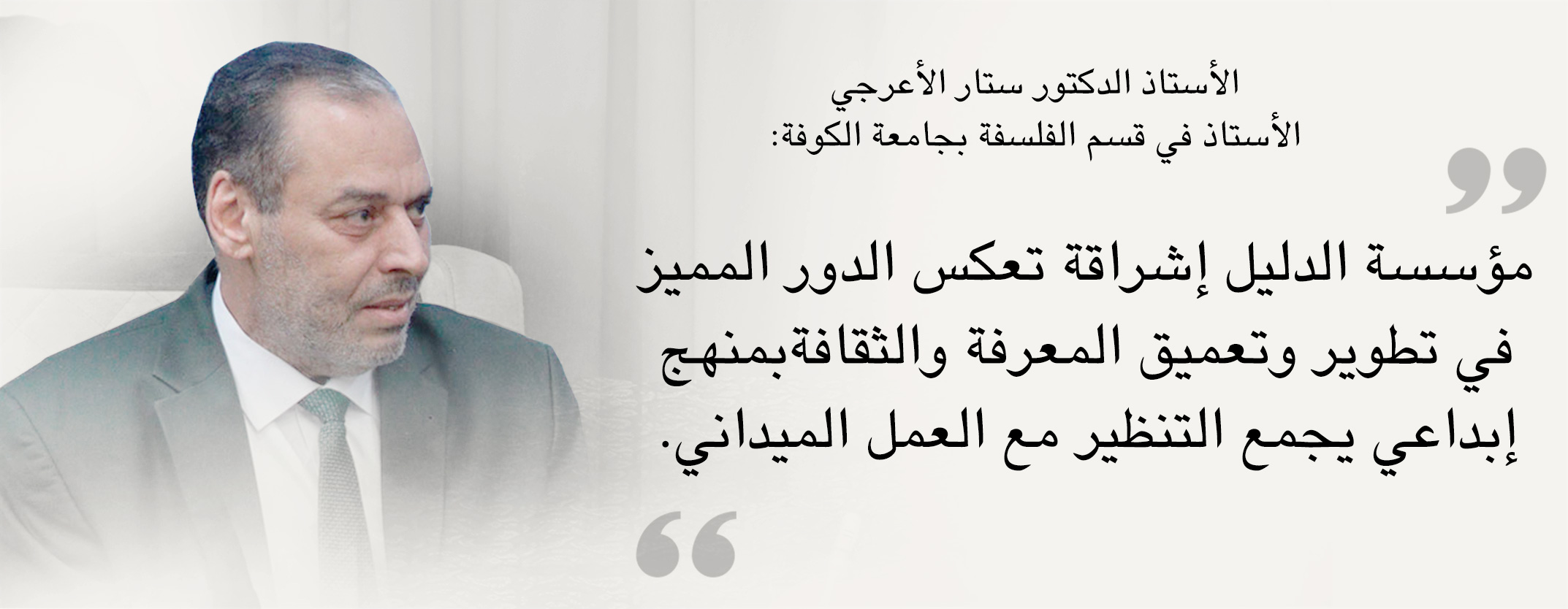

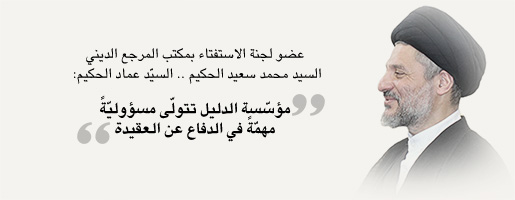
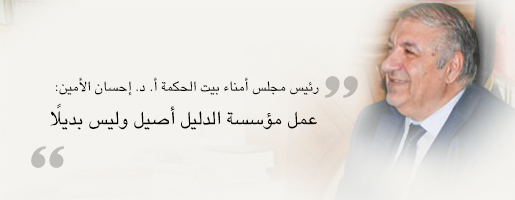
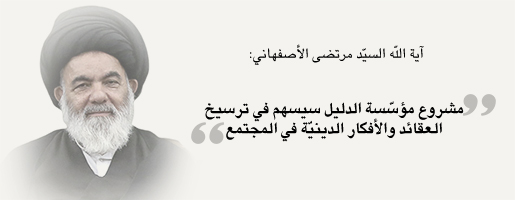
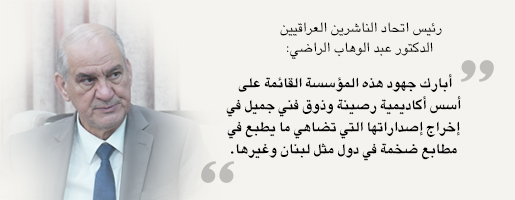

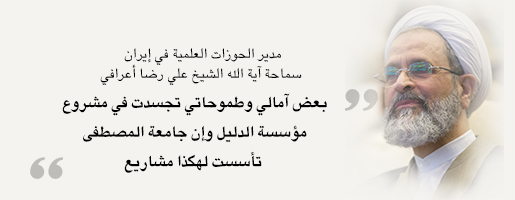


كان التعليم في الدول الإسلاميّة له نمطه الخاصّ المعبّر عنه بـ "الكتاتيب أو الملالي"، وهو تعليمٌ يقام عادةً في المساجد والجوامع أو في أماكن غير رسميّةٍ، ويعتمد تحفيظ القرآن وتعليم اللغة العربيّة بالدرجة الأساس، ويبدأ الطفل في هذا التعليم في سنٍّ مبكّرةٍ من الرابعة أو الخامسة، وبالرغم من بدائيّة هذا التعليم وعدم مواكبته للعصر، بيد أنّه كان يؤمّن للمتعلّم كمًّا معرفيًّا معتدًّا به، باعتبار أنّ تحفيظ المتعلّم القرآن ومنظومات النحو الشعريّة يجعله يمتلك عددًا هائلًا من مفردات لغته الأمّ، الأمر الّذي يجعل منه شخصيّةً واثقةً بنفسها صعبة المراس وقادرةً على التحدّي الثقافيّ والمعرفيّ؛ لذا عمد مستعمرو البلدان الإسلاميّة إلى إقصاء هذا النمط من التعليم واستبداله بمدارس حكوميّةٍ على النمط الغربيّ، محاولين تضعيف اللغة العربيّة الّتي تنشأ منها ثقافة المجتمعات الإسلاميّة وفكرها، ففي الجزائر سنّ المستعمر قانونًا يمنع التعليم باللغة العربيّة، وفرضت بدلًا عنها اللغة الفرنسيّة، كما ينقل (Jansen) في كتابه (Militant Islam)(1)، وفي مصر بالرغم من وجود مدارس على النمط الحديث تسمى بالأميرية و غير الأميرية وكذا الأزهر، التي كانت تعتمد اللغة العربية قاعدة للتعليم فيها، إلا أن المحتل بعد ذلك ابدلها بأحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنساوية، وضعّف الاهتمام باللغة العربية رويدا رويدا(2)، وفي العراق رُغّب الناس ـ في ظل الاحتلال ـ بإرسال أبنائهم إلى المدارس الحكوميّة من أجل تعليمهم اللغة الإنجليزيّة بحجّة أنّ هذه اللغة تنفع في التجارة، ولولا هذه الخدعة ما أرسل الناس أبناءهم إلى تلك المدارس كما في مذكرات المس بيل؛ لأنّ التعليم التقليديّ (الكتاتيب) كان يلبّي طموح أولياء أمور الطلبة(3)، ولسنا رافضين تعليم اللغة الإنجليزيّة أو أيّ لغةٍ أجنبيّةٍ أخرى؛ لأنّ هذا ممّا يزيد من ثقافة المجتمع وتطلّعاته، إنّما نرفض أن يكون هذا التعليم على حساب لغة المجتمع الأمّ الّتي هي مصدر ثقافته وأصالته.
وقد أثارت سياسة الاستعمار مخاوف رجال التربية والساسة العراقيّين وقلقهم، بعد اتّخاذ المستعمرين أساليب ترمي إلى تكريس اللغة الإنجليزيّة على حساب اللغة العربيّة، فجدول الدروس في المدارس الحكوميّة الّذي طرح آنذاك يزيد حصص اللغة الإنجليزيّة في كلّ سنةٍ، ويقلّل من حصص اللغة العربيّة(4)، وقد اشترط الاحتلال عدم فتح أيّ مدرسةٍ ابتدائيّةٍ إلّا بوجود معلّم لغةٍ إنجليزيّةٍ(5)، مضافًا إلى أنّ كثيرًا من المدرّسين في تلك الحقبة لم يكونوا عُربًا، بل كانوا بريطانيّين وهنودًا، ولترغيب أبناء المسلمين في التسجيل بالمدرسة الأمريكيّة التبشيريّة في البصرة آنذاك يمنح كلّ طالبٍ مبلغًا من المال، وهذه المدرسة تعنى بأبناء المسلمين في الدرجة الأولى، وقد أخذت على عاتقها الإشراف على المدارس الابتدائيّة عامّةً؛ لأنّها كانت تخرّج معلّمين، ومضافًا إلى هذه المدرسة كانت هناك مدرستان أخريان في البصرة تأخذ المنح من الحكومة البريطانيّة بشرط أن يكون التعليم فيها باللغة الإنجليزيّة(6)، وأيضًا كان يصحب التعليم في هاتين المدرستين تبشيرٌ للديانة المسيحيّة، تقول المس بيل إنّ هذه المدارس كان يتلى في صفوفها الكتاب المقدّس يوميًّا من دون أيّ اعتراضٍ من آباء الطلبة المسلمين، وكان هذا الكتاب يحظى باحترام نفس الطلبة المسلمين إلى درجةٍ قد تفوق الطلبة المسيحيّين(7)!
وبهذه الأساليب وغيرها جعلوا المتعلّم المسلم في حالة انفصالٍ عن واقعه المعرفيّ والثقافيّ، الأمر الّذي ساهم في سهولة السيطرة على عقول المجتمعات وقهرها، وتحويلها إلى وسائل إنتاجيّةٍ عاجزةٍ عن إدارة نفسها بنفسها. وتخبرنا صفحات التاريخ الحديث عن معاناة وزراء المعارف العراقيّين من تدخّلات المستشارين البريطانيّين في التعليم إبّان الحكم الملكيّ زمن الانتداب البريطانيّ(8)، وهذا هو حال المسيرة التعليميّة في بلادنا، وممّا زاد الطين بلّةً أنّ القرار التعليميّ أصبح تحت هيمنة منظّمةٍ عالميّةٍ تدعى (اليونسكو)(9)، وهي منظّمةٌ ذات نزعةٍ حسّيّةٍ وضعيّةٍ، تولّت بدورها مهمّة تحديد المناهج التعليميّة ضمن أطرٍ ومقاساتٍ خاصّةٍ، فهذه المنظّمة لا تؤمن بغير الحسّ والتجربة مبدأً وطريقًا للمعرفة الواقعيّة، وقد كرّست هذا المنهج بقوّةٍ في المستويات الدراسيّة كافّةً؛ الأمر الّذي سلب المناهج المعرفيّة الأخرى فاعليّتها وقيمتها عند المتعلّمين، كما سبّب هيمنة النزعة الوضعيّة المسخّفة للحقائق الوجوديّة غير المحسوسة.
وبالرغم من أهمّيّة التعليم في المجالات العلميّة الطبيعيّة، وما لها من آثارٍ ومنافع جمّةٍ، ولٰكن من المؤسف أن يكون هذا على حساب الرؤية الدينيّة والعقديّة للمجتمع.
وقد ساهمت الحكومات في العالم الإسلاميّ - بقصدٍ أو بدون قصدٍ - في إضعاف التعليم الدينيّ، من خلال إقحام مادّة التربية الدينيّة ضمن مفردات التعليم المدرسيّ، فقد ازداد الوضع سوءًا بسبب هزالة طرح المنهج الدينيّ، والرؤية المشوّشة والمشوّهة عن الدين، فلم توضع هذه المادّة وفق منهجٍ معرفيٍّ علميٍّ رصينٍ، بل اقتُصر على أسلوب التلقين من خلال النصوص الدينيّة غير المدعّمة بأيّ استدلالٍ منطقيٍّ أو علميٍّ، وبالتالي أصبح الدين في الدراسات الأكاديميّة مادّةً تشكّل عبئًا ثقيلًا على المتعلّمين، ومدعاةً للضجر والملل، وقد تركت في أذهانهم انطباعًا خاطئًا حول الدين، فقد فهموا من الدين أنّه مجرّد إرثٍ اجتماعيٍّ يشتمل على طقوسٍ وممارساتٍ فلكلوريّةٍ، ويشتمل كذٰلك على مجموعة قصصٍ ومواعظ وإرشاداتٍ لجعل السلوك الفرديّ والاجتماعيّ على نمطٍ معيّنٍ، والمحصّلة ألّا جدوى من الدين في الحياة العلميّة!
وليس من المستبعد أنّ عمليّة إقحام الدين بهذه الطريقة تقف وراءها دوائر مشبوهةٌ غرضها الانتقاص من الدين وإضعافه، والقضاء على الشعور الدينيّ لدى المتعلّمين، وطمس الهوية الدينيّة لدى مجتمعاتنا؛ تمهيدًا لعمليّة استعمارٍ فكريٍّ شاملٍ، هو من أخطر أشكال الاستعمار.
إنّ تكريس المنهج الحسّيّ في عقول أبنائنا المتعلّمين وإغفال المناهج الأخرى - سيّما المنهج العقليّ - وافتعال جدليّة العلم والعقل، أو العلم والدين، هو ما جعل ذهنيّة المتعلّمين لا تستسيغ فكرة الدين، ولا تتعاطى مع مسائل ما وراء الطبيعة على أنّها حقائق علميّةٌ، فأصبحت مفردة العلم في العرف الأكاديميّ تدلّ على الحسّ والتجربة حصرًا، ممّا خلق فجوةً كبيرةً بين الواقع العلميّ والدين في أذهان المتعلّمين.
ومن هنا فإنّ المتعلّم في المدارس الأكاديميّة لا يجد - حسب ما تعلّمه في تلك المدارس - أيّ صفةٍ علميّةٍ لمعطيات العقل والدين، بل يرى أنّها نتائج متمرّدةٌ على القانون العلميّ (منهج الحسّ والتجربة) ومتعاليةٌ عليه، وهذا ما جعل الأكاديميّ في المجتمعات المتديّنة يعيش أزمة المنهج في الموروث الدينيّ، فغاية ما يستطيع فعله إيجابيًّا احتضان الثقافة الدينيّة بطريقةٍ دراماتيكيّةٍ، كونها تمثّل إرث الآباء والأجداد، كما ويتلقّى الطقوس والممارسات الدينيّة كنوعٍ من الفلكلور الشعبيّ بمؤثّرات العقل الجمعيّ، ومتى ما تغيّرت الظروف يكون الدين أوّل المتغيّرات.
وقد أنتجت لنا هذه الأزمة اتّجاهاتٍ في الوسط الدينيّ، فهنالك من يعيش حالة الازدواجيّة الفكريّة والتذبذب بين المنهج والمعتقـد، وهنـاك من طغـت عليـه حالـة الاستسـلام والتبعيّـة للنموذج الغربيّ والتمرّد على التراث الدينيّ بكلّ أشكاله، وثمّة من أوصد الباب أمام معطيات العلم كافّةً واتّخذ سبيل السلفيّة طريقًا، وغلّف العقل بالفهم العرفيّ الساذج للنصوص الدينيّة، وفضّل الانكفاء على المورث الدينيّ بكلّ ما فيه من غثٍّ وسمينٍ.
والّذي يقف وراء كلّ هذا الإرباك المعرفيّ في فهم الحقيقة هو فقدان انسجام الرؤية العقديّة (ما وراء الطبيعيّة) مع المنهج الحسّيّ التجريبيّ الّذي رافق مسيرة الأكاديميّ التعليميّة طيلة حياته.
(1) See: G. H. Jansen, Militant Islam, pp. 68-72.
(2) انظر: جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ص 35.
(3) انظر: المس بيل، فصولٌ من تاريخ العراق القريب، ص 35.
(4) انظر: أحمد مطلوب، حركة التعريب في العراق، معهد البحوث والدراسات العربيّة، ص 70؛ الحصريّ، ساطع، مذكّراتي في العراق (1921-1941)، ج 1، ص 110.
(5) انظر: المس بيل، فصولٌ من تاريخ العراق القريب، ص 35.
(6) انظر: المصدر السابق.
(7) انظر: المصدر السابق، ص 37.
(8) انظر: العامري، راهي، وزارة المعارف في عهد الانتداب البريطانيّ (1921-1932)، مجلّة دراسات تربويّة، العدد الثامن، ص 85 - 96.
(9) منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة (بالإنجليزيّة: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)، وهي منظّمةٌ أمميّةٌ تأسّست سنة 1945 ومقرّها الرئيسيّ في باريس، وهدفها المعلن رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة، وأعضاؤها 193 دولةً وكيانًا.
تعليقات الزوار