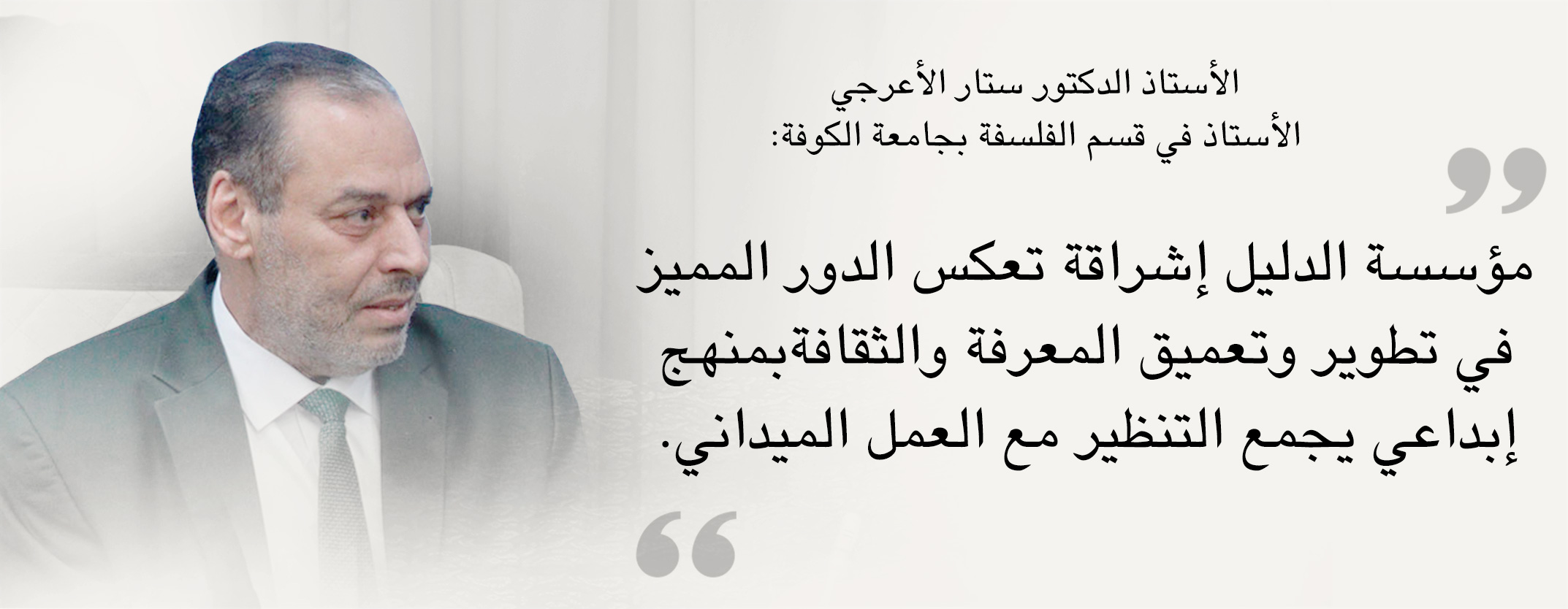
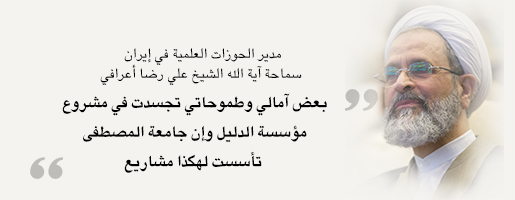
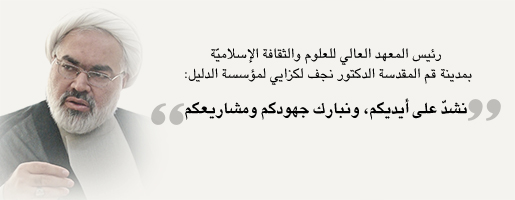


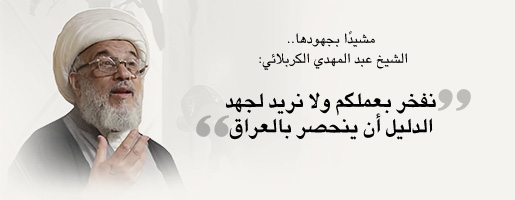
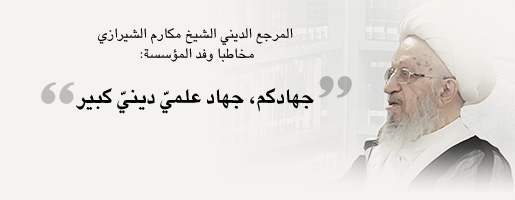



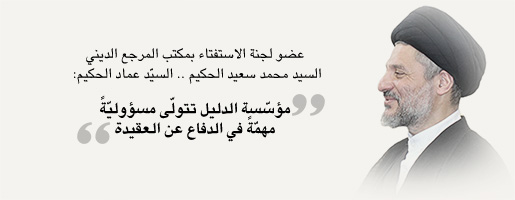


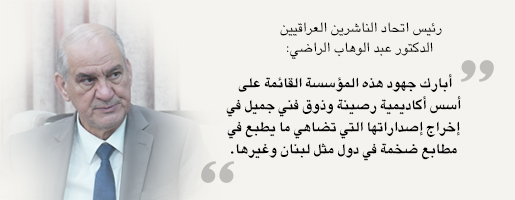

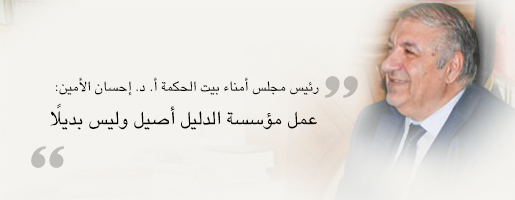
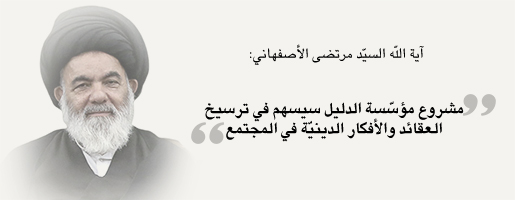
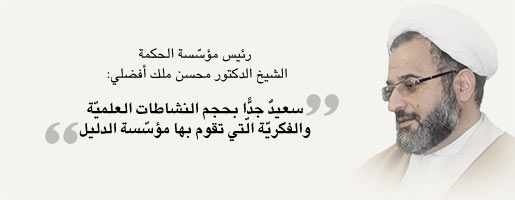
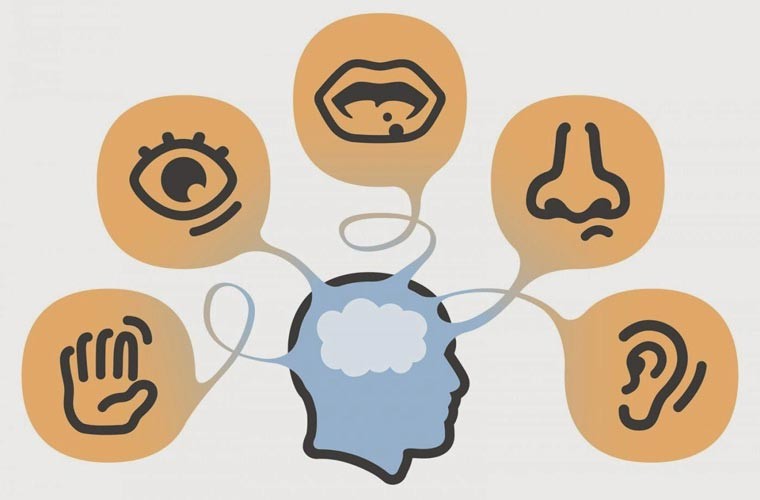
أوّل الأدوات المعرفيّة الّتي من خلالها يتعرّف الإنسان على الواقع الخارجيّ الّذي يحيط به بعد خروجه الى عالم الدنيا هو الحسّ، وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة بقوله: {وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (1)، ولكنّ مدركاتها تكون جزئيّةً محدودةً بشخص المدرك بها فقط، وأمّا التجربة فهي تطويرٌ لعمل الحواسّ بتكرار الظواهر المشاهدة، وتحت ظروفٍ يمكن التحكّم بها من قبل الإنسان؛ ليتوصّل العقل من خلالها إلى نتيجةٍ كلّيّةٍ يمكن تطبيقها في كلّ المجالات الّتي لها علاقةٌ بتلك الظاهرة، فالتجربة في الحقيقة عمليّة تطويرٍ لعمل الحواسّ للترقّي بالنتائج الجزئيّة إلى نتيجةٍ عامّةٍ كلّيّةٍ.
معنى الحسّ
يمتلك الإنسان نوعين من الحسّ هما: الحسّ الظاهريّ وهو المتمثّل بالحواسّ الخمس المعروفة (الباصرة، السامعة، الذائقة، الشامّة، اللامسة)، والحسّ الباطنيّ المتمثّل بـ (الحسّ المشترك، الخيال، المتصرّفة، الواهمة أو المتذكّرة) كما هو مذكورٌ في علم النفس الفلسفيّ(2)، والكلام فعلًا في الحسّ الظاهريّ.
والحواسّ الظاهرة عند الحكماء عبارةٌ عن مجموعة قوًى للنفس منبثّةٍ في الجوارح المعروفة، متى ما صادفت ما يلائمها من المدركات وأصبح في متاولها، أدركت النفس صورةٌ حسّيّةٌ عن ذلك الشيء المحسوس، فالمدرك حقيقةً هو النفس الإنسانيّة ولكن بتوسّط تلك الحواسّ، وليس المدرك هو نفس تلك الحواس، بمعنى أنّ إدراك النفس للصور المحسوسة موقوفٌ على وقوع تلك المحسوسات المادّيّة تحت متناول الحواسّ الظاهرة، وإنّما تسمّى بالمدركات الحسّيّة فلأجل الآلة الّتي بها أدركت النفس.
وأمّا عند أصحاب النظرة المادّيّة المحضة فهي عبارةٌ عن مجسّاتٍ مادّيّةٍ خاضعةٍ لتركيبة الجهاز العصبيّ والدماغ عند الإنسان، فيكون عملها مادّيًّا بحتًا.
المدركات الحسّيّة
الإدراك عبارةٌ عن أخذ صورة المدرك بنحوٍ من الأنحاء، فإذا كان الإدراك لشيءٍ مادّيٍّ فإدراكه هو أخذ صورته مجرّدةً عن المادّة تجريدًا ما، وهو في مرتبة الإدراك الحسّيّ تجريدٌ ناقصٌ عن المادّة ولواحقها، فهو يأخذ الصورة عن المادّة مع اللواحق المادّيّة الّتي تعرض الصورة بسبب المادّة، وهي التكثّر والانقسام، وكذلك الكمّ والكيف والوضع والأين، وهذا الأخذ يكون مشروطًا بوجود نسبةٍ بين المادّة والقوّة الحسّاسة، بمعنى أنّه لا بدّ من وجود المحسوس في متناول الحاسّة لتحصل الصورة الحسّيّة، وإذا غابت المادّة فليس له أن يستثبت تلك الصورة، فينتفي هذا الأخذ (3).
ولا بد من الالتفات إلى أن قوى الإدراك الحسّيّ تدرك الكيفيّات المحسوسة في الأمور المادّيّة فقط، فهي لا تتعدّى تلك الكيفيّات لتدرك طبيعة الشيء المادّيّ كالجسم، وهناك من مدركاتها ما يشترك بين بعضها، وهناك ما هو مختصٌّ، فالباصرة واللامسة تشتركان في إدراك الأشكال مثلًا، وهناك ما يكون مختصًّا بكلّ واحدةٍ منها، كالألوان الّتي لا تدركها إلّا الباصرة.
قيمة الإدراكات الحسّيّة
هناك من شكّك في قدرة الحسّ على كشف الواقع المدرك بالنسبة له، وقد استدلّ الشكّاكون على ذلك بالأخطاء الّتي تقع للحسّ في بعض الحالات.
والصحيح في هذه المسألة أنّ منشأ الخطإ إمّا أن يكون راجعًا إلى نفس تلك الحواسّ أو إلى الواقع المحسوس، وكل ما يرجع إلى نفس الحاسّة فهو يكون بسبب عدم سلامة الحواسّ وبقائها على وضعها الطبيعي، لأجل إصابتها بالضعف أو المرض أو ما شابه ذلك، وهذا لا يقدح؛ لأنّ مطابقة الإدراك الحسّيّ للواقع المحسوس مشروطٌ بسلامة تلك الحواسّ، وكثيرًا ما يتوجه الإنسان في حالة المرض إلى تغير محسوساته عن الحالة الطبيعيّة.
وأمّا ما يرجع إلى نفس الواقع المحسوس فلا بدّ أن نعرف أنّ الحواسّ آلاتٌ مادّيّةٌ، يكون إدراكها للواقع المحسوس متأثّرًا بعوامل مادّيّةٍ وخاضعًا لمجموعةٍ من القوانين الطبيعيّة الفيزيائيّة أو الكيميائيّة، الّتي قد تتحكّم بعمل تلك الحواسّ أو بطريقة اتّصالها بذلك الواقع؛ لذلك لا بدّ للعقل من أخذ تلك المتغيّرات عند الحكم على الواقع من خلالها، وإلّا فلن يكون حكمه صحيحًا، فمثلًا عندما تأخذ الباصرة صورةً للقلم ونصفه في الماء فيبدو منكسرًا فهذا ليس خطأً في الصورة المحسوسة له، بل إنّ هذا الانكسار الّذي يبدو هو في الواقع الموضوعي لتلك الصورة، وذلك بسبب اختلاف عامل انكسار الضوء في الهواء عنه في الماء، ولذلك لو اخذت صورة فوتوغرافية لذلك القلم بتوسط الكامرة لظهرت الصورة على طبق ما ادركه الحس البصري، وهكذا بالنسبة للظواهر الأخرى، وهذا يدلّ على أن الحسّ ناقلٌ أمينٌ للواقع الّذي يتصل به، والخطأ إنّما يكون من قبل العقل عند حكمه على الواقع المحسوس مع عدم الأخذ بنظر الاعتبار تلك المتغيرات المادّيّة في الواقع المحسوس، وقد تمكن الإنسان عن طريق تكرار التجارب من تشخيص الكثير من تلك المتغيّرات ووضعها في حساباته عندما أصبح يحكم على المحسوسات من خلال الحواسّ.
وهناك من يدّعي أنّ الحسّ له قيمةٌ في الجانب العمليّ فقط، إذ يعتمد عليه في أداء الصناعات والحرف، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه في التعرّف على طبائع الأشياء الّتي يدركها؛ لأنّه لا ينال إلّا الخواصّ المحسوسة للأشياء المادّيّة، كاللون والشكل والحرارة والبرودة وهكذا، وهذا لا ينفع إلّا في إمكان التعامل مع تلك الأشياء والاستفادة من منافعها، والتحرّز عن الخطر الّذي يمكن أن تسبّبه.
بيد أنّ الواقع كما قلنا إنّ الحسّ أمينٌ في نقله لصورة الواقع، ويبقى الدور دور القوى الداخليّة للإنسان، فهذه الصور الحسّيّة لها أهمّيّةٌ كبرى في أنّها تكون مبدأً لإدراك الأمور المادّيّة في مرتبة الخيال والتعقّل، وذلك بتجريدها من قبل تلك القوى بمراتب مختلفة، فالخيال يجرّدها عن المادّة مع الاحتفاظ بالعوارض المادّيّة لها، والعقل يجرّدها تجرّدًا تامًّا ليحوّلها إلى معنًى وصورةٍ معقولةٍ، فإذا لم يتمّ أخذ صورةٍ محسوسةٍ عن أفراد الطبيعة وتحليلها من قبل الخيال والعقل، لما أمكن للخيال تحصيل صوره والتركيب بينها ليكون لها هذا الدور في الفنون والصناعات البديعة الّتي يجيدها الإنسان، ولما أمكن للعقل تحصيل المعاني الّتي عنده عن الطبائع المادّيّة وأحكامها، والانتقال من خلالها عن عالم الطبيعة إلى عالم التجرّد والقدس الإلهيّ، عن طريق القياسات والبراهين العقليّة.
هذا بالنسبة إلى مجال التصور، وأمّا بالنسبة إلى مجال العلم التصديقيّ فإنّ الحسّ يساعد العقل على الحكم في القضايا الجزئيّة ذات الموضوعات المحسوسة فقط، ككون هذا الجسم أبيض، وشكله مكعبًا، وهو أملس وهكذا، نعم قد يكون استقراء الإدراكات الجزئيّة منبّهًا على حكمٍ عقليٍّ أوّليٍّ، مركوزٍ في النفس غير متوجّهٍ إليه، وليست مولّدةً له، وقد تكون مبدأً لتولد حكمٍ كلّيٍّ، ولكن بتوسط تكرار المشاهدة وانضمام القياس الخفيّ، ولكنّه يسمّى عندئذٍ تجربةً(4)، وستأتي.
قال المحقّق الطوسيّ: (والحواسّ لا تفيد رأيًا كلّيًّا، وهي مبادئ اقتناص التصوّرات الكلّيّة والتصديقات الأوّليّة، فمن فقد حسًّا فقد علمًا).
وقال العلّامة الحلّيّ في شرحه: (أقول الإحساس هو إدراك الشيء المقترن بمادّةٍ معيّنةٍ بشرط حضوره عند المدرك، فبالضرورة يكون جزئيًّا لا يمكن صدقه على غيره، فالحواسّ لا تفيد رأيًا كلّيًّا، وإنّما تفيد الجزئيّ، فالعلم بأنّ كلّ نارٍ حارّةٌ حكمٌ عقليٌّ لا حسّيٌّ، فإنّ الحسّ إنّما يفيد أنّ هذه النار المحسوسة حارّةٌ، أمّا أنّ كلّ نارٍ حارّةٌ فلا.
نعم الحواسّ مبادئ اقتناص التصوّرات الكلّيّة والتصديقات الأوّليّة؛ لأنّ النفس أوّل خلقها خاليةٌ من كلّ العلوم - كأنفس الأطفال - وقابلةٌ لها، وواجب الوجود عامّ الفيض؛ فلا بدّ من توقّف الأثر على الاستعداد، وهو هنا مستفادٌ من الحواسّ، فإنّ من أحسّ بالجزئيّ استعدّ لإدراك الكلّيّ، ولحصول مناسباتٍ ومبايناتٍ هي أحكامٌ ضروريّةٌ وتصوّراتٌ كلّيّةٌ عقليّةٌ حاصلةٌ من واجب الوجود - تعالى - بسبب الاستعداد السابق؛ ولهذا حكم المعلّم الأوّل بأنّ من فقد حسًّا فقد علمًا يؤدي إليه ذلك الحسّ؛ لزوال الاستعداد الّذي هو شرطٌ في العلم) (5).
التجربة
التجربة: عبارةٌ عن تكرار المشاهدة لجزئيّات متكثّرةٍ من طبيعةٍ واحدةٍ، تحت ظروفٍ مختلفةٍ؛ للوصل إلى حكمٍ كلّيٍّ موضوعه تلك الطبيعة الكلّيّة.
فالتجربة في حقيقتها غير الاستقراء بالمعنى المصطلح؛ لأنّه يكون عشوائيًّا في اختيار الجزئيّات المستقرأة، وأمّا التجربة فهي عبارةٌ عن استقراءٍ، ولكنّه منظّمٌ لجزيّئاتٍ كثيرةٍ تحت ظروفٍ مختلفةٍ، أي: أنّ تغيير ظروف التجربة يكون متحكّمًا به من قبل نفس المجرّب؛ وذلك للوصول إلى حكمٍ وقاعدةٍ كلّيّةٍ من خلال ذلك، ويتمّ هذا بأن يؤتى بعيّناتٍ كثيرةٍ من المادّة الّتي يراد إجراء التجربة عليها، وتكرّر التجربة على كلّ عيّنةٍ مع تغيير الظروف المختبريّة من قبل المجرّب نفسه، وهكذا تكرّر العمليّة على كلّ عيّنةٍ إلى أقصى عددٍ ممكنٍ من العيّنات؛ وذلك لأجل معرفة أنّ صدور الأثر المعيّن هل هو راجعٌ إلى طبيعة المادّة الّتي تنتمي لها تلك العيّنات، أو لدخالة أمرٍ خارجٍ عن تلك الطبيعة، فإذا استقصينا كلّ الأمور الخارجيّة المحتمل دخلها في صدور الأثر واستبعدناها، أو شخّصنا أيّ تلك الظروف له دخالةٌ في صدور الأثر منها، أمكننا القول إنّ صدور هذا الأثر عن تلك الطبيعة لوحدها، أو تلك الطبيعة تحت ذلك الظرف المعيّن كان دائميًّا أو في أكثر الحالات(6).
ولأجل الحصول على قاعدةٍ كلّيّةٍ تجعل هذه النتيجة المستحصلة من تكرار التجربة صغرى في قياسٍ خفيٍّ، كبراه: إنّ الاتّفاقيّ لا يكون دائميًّا ولا أكثريًّا(7)، فمثلًا لو جرّب علماء المعادن تسخين عيّناتٍ مختلفةٍ من الحديد مثلًا، فوجدوا أنّها تتمدّد بالتسخين، وكرّروا هذا الأمر على تلك العيّنات المتكثّرة وفي ظروفٍ مختلفةٍ فحصل لهم الأثر نفسه دائمًا، أو في أكثر الحالات، أمكنهم القول إنّ حصول أثر تمدّد الحديد كان أكثريًّا أو دائميًّا عند تسخينه، والاتّفاقيّ لايكون دائميًّا ولا أكثريًّا، فتمدّد الحديد عند تسخينه ليس اتّفاقيًّا، بل هو ذاتيٌّ، والأثر الذاتيّ لا يتخلّف، فأمكن وضع قاعدةٍ عامّةٍ مفادها أنّ كلّ حديدٍ يتمدّد عند تسخينه.
حدود التجربة
لمّا كانت التجربة تعتمد بالأساس على الحسّ فلا يمكن أن تتخطّى حدود المحسوسات، بل تبقى تدور في حدود ظواهر الطبيعة الّتي يعبّر عنها بالكيفيّات المحسوسة، وهي الّتي تنالها الحواسّ الخمس.
ولا بدّ من الالتفات الى أنّ في التجربة نقطة ضعفٍ، تكمن في أنّ القطع بكون الأثر دائميًّا أو أكثريًّا لطبيعة المؤثّر يتوقّف على تجربة كلّ أفراد الطبيعة الكلّيّة، وتحت كلّ الظروف الّتي يتوقّع دخالتها في الحكم، وهذا ممتنعٌ وقوعًا بطبيعة الحال، فيبقى الدوام والأكثريّة مظنونًا، محتملًا لعدمه، ولكنّ تكرار التجربة كثيرًا يؤدّي إلى ضعف هذا الاحتمال، إلى أن يصل إلى مرحلةٍ لايحتفظ به العقل لضعفه، فلا يعير له أيّة أهمّيّةٍ من جهة ترتيب الأثر العمليّ على التجربة، إلّا أنّه لا يزول أبدًا من الناحية النظريّة مهما قلّت قيمته؛ ولذلك وقع الخلاف والإشكال في إمكان اعتبار التجربيّات من مبادئ البرهان العقليّ الموجب لليقين بالمعنى الأخصّ.
هذا من ناحية التصديقات، وأمّا من ناحية تحصيل العلوم التصوّريّة فإنّ التجربة قد تنفع كثيرًا في تشخيص العوارض الذاتيّة للطبائع المختلفة، وهي تنفع في تشكيل رسوم تلك الطبائع، الّتي تنفع في التمييز التامّ لها عن غيرها، وهذا هو الغاية للعلم التصوّريّ في العلوم الطبيعيّة والصناعات المختلفة، ففي علم المعادن مثلًا لا يهمّ كثيرًا معرفة ماهيّة تلك المعادن، بل المهمّ هو معرفة آثارها وخواصها الّتي تتميّز بها، ويمكن الاستفادة منها في مختلف الصناعات.
المنهج التجريبيّ
وهو المنهج الّذي يعتمد على التجربة كمصدرٍ أساسيٍّ للمعرفة، وله ميزانٌ صناعيٌّ وضوابط مقرّرةٌ في كيفيّة إجراء التجربة، وعدد مرّات تكرارها للوصول إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها، وقد تكفّل علم المنطق منذ ظهوره بالبحث عن التجربة وقواعدها، وأمّا موضوع هذا المنهج وحدوده فقد تبيّن عند البحث عن أدات التجربة، وهو الموضوعات المادّيّة وحدوده الظواهر المادّيّة المحسوسة، فكان لا بدّ أن يستعمل في العلوم الطبيعيّة فقط، ولكن تطوّر العمل بهذا المنهج في أوربّا في القرن السابع عشر بعد ظهور فرانسيس بيكون، ووضعه لكتاب الأورگانون الجديد ( Novel Organum)، ولمّا رأوا نجاح هذا المنهج وتطوّر العلوم الطبيعيّة بفضله، طبّقوه في كلّ العلوم الإنسانية، وعدّوه المنهج العلميّ الوحيد المعتمد في مختلف العلوم، ممّا أدى إلى فصل العلم عن الفلسفة والدين.
نعم يمكن الاستفادة من المنهج التجريبيّ في بعض المقدّمات الّتي تنفع في الاستدلال العقديّ، مثل وجود النظام في العالم، وبيان استحكام هذا النظام، وهو ينفع في واحدةٍ من أهمّ براهين إثبات الخالق للعالم وهو ما يسمّى ببرهان النظم.
الهوامش:
1 - سورة النحل: الآية 78.
2- انظر: النفس من كتاب الشفاء، ابن سينا، ص227 ومابعدها.
3- انظر: النفس من كتاب الشفاء، ابن سينا، ص81 وما بعدها.
4- انظر، برهان الشفاء، ابن سينا، ص223.
5- الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، العلامة الحلي، ص205.
6- انظر: برهان الشفاء، ابن سينا، ص95.
7- انظر: شرح الإشارات والتنبيهات، المحقق الطوسي، ج1، ص216 ـ 217.
تعليقات الزوار